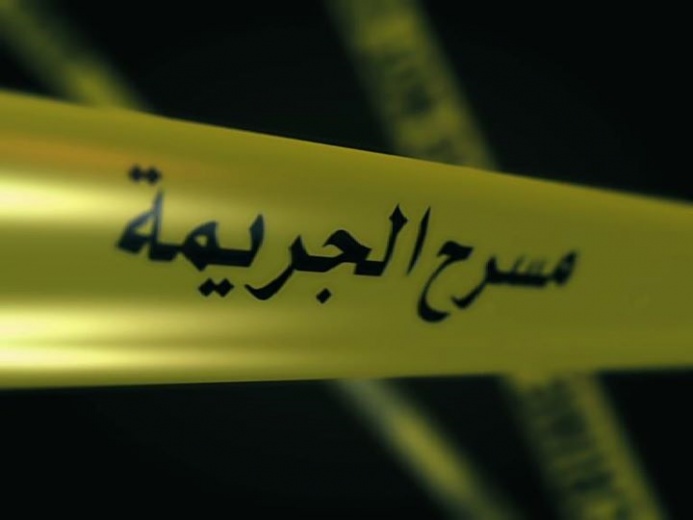نشهد في الآونة الأخيرة أشكالاً صادمةً من العنف والجرائم مهددة للبناء الأسري
الأسرة لم تعد تشكل الجدار الأخير لحماية المجتمع من الجرائم وإن كنّا نتمنّى ذلك
الجريمة انعكاس لبنىً خاطئة أو غير متوازنة في الأسر التي انحدر منها الفاعلون
الجرائم التي نشاهدها أعراضٌ ظاهريةٌ لمشكلة استفحلت في جوهرها الاقتصادي والقيمي
يجب الاستثمار في الإعلام وإشاعة التوعية بصورة علمية للحد من الجريمة في المجتمع
عمّان – رائد صبيح
شهد المجتمع الأردني خلال الأسابيع الماضية زيادةً ملحوظة في “الجرائم الصادمة”، لا سيما وأنّ عددًا كبيرًا منها وقع في حدود الأسرة الواحدة الصغيرة التي من المفترض أنّ تكون روابطها الأكثر قوةً ومودةً ورحمة، الأمر الذي يدفع لإثارة تساؤلات مهمّة حول القضية، ووضع “درهم الوقاية” منها على طاولة الأسرة الأردنية الكبيرة وما تُعرف به من تماسك وتحابٍ وتسامحٍ، وهو الدور الذي بدأ بالتراجع والخفوت اليوم والحاجة الماسة لـ “قنطار علاج”.
“البوصلة” في حوارها العميق مع الخبير في علم الجريمة وأستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين وقفت على أهمّ الأسباب المؤدية لمثل هذه الجرائم، والتغيرات الهائلة والتحديات الكبيرة التي باتت تواجهها الأسرة الأردنية بميلها نحو “النزعة الفردية والأنا المتضخمة” على حساب “المجتمع واستقراره وروابطه القوية”، وتخلّي العديد من المؤسسات عن مسؤولياتها وعلى رأسها الحكومة والقطاع العام، والتي تُعد عمادًا للمجتمع الاردني والإسهام في تنشئة الأفراد في أسرٍ قوية تشكل مجتمعًا متماسكًا وقويًا في وجه انتشار الجرائم.
بداية القصة والأسرة
يرى الدكتور حسين محادين في قراءته المتمعنة لهذه القضية، أنّه ومن حيث المبدأ علينا أن نقول إنّ الأسرة يبدأ إنشاؤها قبل أن تدوّن في عقد الزواج، فمقدمات عقد الزواج بين الزوجين تؤثر بشكلٍ واضحٍ في فرص بناء علاقات متوازنة داخلية أو أن تكون هذه العلاقات بين مشروع الزوجين لاحقًا علاقات غير متكافئة قائمة على التسلط أو قائمة على عدم التعاون بشكلٍ أو بآخر.

ويلفت محادين إلى أنّ مردّ هذا التأثير القبلي (أي قبل البدء الفعلي في موضوع الزواج) هو أنّ كلا الزوجين انحدر من بيئة موازية للآخر على العموم، فكلٌ منهما يحمل خبرات طفولة خاصة به، وتجارب خاصة به.
ويتابع، وبالتالي عندما يلتقيان تحت مظلة الزواج تبدأ هذه الخبرات السابقة بالظهور على شكل سلوكات وممارسات حياتية إمّا أن تكون خبرة كل منهما قائمة على التوافق وقائمة على المرونة والقدرة على التكيف، وإمّا أن تكون هذه الخبرات “المؤلمة القبلية” قائمة ومبنية على “الاغتراب” أي الأنا المتسيدة.
ويقول محادين: نبدأ بقراءة الاسرة ليس من لحظة نشوئها ولكن من مقدمات حصولها، هنا تظهر أهمية وصدقية طبيعة العلاقة بين الزوجين من حيث القرابة والتكافل والتعاون والتساند ومن حيث عمق ومنسوب “السكنى بينهما”.
ويستدرك: ولذلك، نحن عمليًا نعالج بصورة فوقية أو “متسرعة” مثل قضايا العنف، عندما نتناولها من حدود نشأة الأسرة نفسها، ويضيف: الآن كلٌ من الزوجين قدم من بيئة، والعلاقات الاجتماعية في مجتمعنا “المتساند نسبيًا” تؤثر على مثل هذه العلاقات.
تحديات تواجه الأسرة الأردنية
ويلفت محادين بالقول: إنّ التحديات التي تواجه الأسرة في الأردن أصبحت تحدياتٍ “بنيوية”، أي قائمة على أسباب البناء ودقة البناء نفسه، لماذا؟ لأننا بدأنا نشهد في الآونة الأخيرة أشكالاً صادمةً من العنف والجرائم، والأهمّ من ذلك، كلها أشكالٌ مهددة للبناء الأسري ذاته، سواءً على الصعيد الداخلي بناءً على ما قلت من حيث دقة وإمكانية وسوية نشأة هذه الأسرة بين الزوجين عندما كانا اثنان فقط، والعوامل الخارجية التي أثرت على الأسرة.
ويضيف بالقول: ومنها تأثيرات العولمية ومظاهر التفكك الأسري نفسه، وارتفاع نسب البطالة والفقر والعوز، والأهمّ من ذلك عدم قدرة أفراد الأسرة (للأسف) على تحمّل بعضهم بعضًا في النطاق الداخلي للأسرة، من حيث تقسيم العمل، واحترام الكبير، والتعاون، واحترام الأنثى.
ويتساءل محادين: “فما بالك عندما يتعلق الأمر في مجتمعٍ أصبحت مؤسساته مثارًا للتشكك من حيث الأدوار والقدرة على توجيه الأفراد”.
ويخلص للقول: لذلك شهدنا ونشهد للأسف أشكالاً مختلفة للعنف، وهي انعكاس لبنىً خاطئة أو غير متوازنة في الأسر التي انحدر منها هؤلاء الفاعلون، والمهم أيضًا أنّ هذه المؤسسات التي كانت تشكل عِمَدَ المجتمع انطلاقًا من الأسرة مرورًا في المدرسة والجامعة وكلها مؤسسات مرجعية تساهم في تنشئة الأفراد، قد أخذت تتراجع عن أدوارها لصالح عوامل جديدة منها التكنولوجيا.
ويضيف: وكيف تساهم التكنولوجيا عبر أدوات التواصل في التأثير على أنماط التنشئة وعلى منظومة القيم الدينية الآخذة في التراجع، وعن الكثافة الأخلاقية التي أصبحت محل تساؤل جراء ملاحظتنا لللسلوكات الواسعة المخالفة لها، ويضاف لذلك كله أنّ الأسرة بطبعها في ظل المعطيات والمؤشرات العلمية في المجتمع الأردني لم تعد تشكل الجدار الأخير وإن كنّا نتمنّى ذلك.
ويذهب لإثبات ما ذهب إليه بالقول: بدليل أنّ العامين الأولين من الزواج كما تشير الإحصائيات العلمية فيهما النسب الأكبر من الطلاق، إضافة إلى أنّ هناك تأخرًا في سنّ الزواج، وظهور مؤسسات وعلاقات وسيطة أضعفت “دور الأسرة البيولوجي” أو “السكنى” في الأسرة من خلال الاستخدامات غير الرشيدة لوسائل التواصل الاجتماعي التي أصبح جُلّها مهددًا للحياة الاسرة ومفسدًا في أحيانٍ كثيرة للعلاقات الزوجية المفترض ان تكون أكثر استقراراً ممّا هي عليه، خصوصًا في ظلّ ارتفاعٍ واضحٍ للقيم الفردية، وفق النموذج الغربي (الحرية الفردية المطلقة) وتراجع (قيم الجماعة) كمؤسسة العشيرة والعائلة أو العلاقات المناطقية، وقد ضعفت من حيث التأثير على الحرية الفردية.
الأفراد أنوية هائمة
ويحذر محادين من أنّ كل فردٍ منا أصبح اليوم “نواة هائمة” على أهوائه ومثلما يريد هو، بغض النظر عن موقف أو اسم العائلة أو المنطقة الجغرافية التي كان ينتسب إليها من جهة، ومن جهة أخرى جراء ضعف التكافل الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي في المجتمع للأسف، اصبح الأفراد عبارة عن أنوية متطايرة لا يحكمهم إلا نقطة انجذابهم للمصلحة والرقم والذات المتورمة.
ويقول: يكفي أن نشير على أنّ البعض للاسف يحرص على تصوير حادث سير ما كي يأخذ به سبقًا أو نشرًا على وسيلة إعلامٍ ما، على أن يقدم خدمات الإنقاذ والمساعدة لأناسٍ يتعرضون أو تعرضوا لحادث هنا أو هناك، ولم يعد يعنينا أنّ هذا المتسول أو ذاك يحمل اسم العائلة حقيقة أو مزيفة.
ويعبر عن أسفه الشديد، لا سيما وأنّ المجتمع وأفراده أصبح لديهم اهتمامٌ كبيرٌ فقط بثقافة الرقم برأسيها، (الجانب المادي الطاغي ومصاحباته وتجارته ومنفعيته)، والرأس الثاني (ثقافة الرقم التي تساعدنا على أن ندير التكنولوجيا وأدواتها بما يعمّق مركزية الجسد والتلذذ أو الحس اللذي في أجسادنا، واستخدامات وسائل التكنولوجيا لغايات فردية بما فيها التجارة والاطلاع على صور ومشاهد وأفلام ليست من واقعنا لكنّها مغرية لنا، لأننّا نعيش أشكالاً متعددة من الازدواجيات في شخصياتنا.
أزمة اقتصادية قيمية
ويوضح محادين: كما أصبحنا بشكلٍ أوضح في هذا الموضوع بعيد تسعينيات القرن الماضي، جراء الخصخصة المتسارعة التي فسخت كل هذه الروابط، والتي وإن كان ظاهرها أخلاقيًا اجتماعيًأ قيميًا، إلا أن جذورها ومحتواها “خلليًا” وجذورها المهددة هي (جذور اقتصادية).
ويؤكد على أنّ ما نشاهده هذه الأيام من أوضاع اقتصادية ضاغطة على المواطنين العاديين، لا سيما شريحة الفقراء، إنّما هو انعكاس لتخلي الحكومات (القطاع العام) كجزء من الخصخصة عن الأدوار التاريخية التقليدية الرعائية التي كان يقوم بها ويحد من خلالها من نسب الفقر او التفاوت الاقتصادي والطبقي في الأردن.
ويلفت إلى أنّ مجتمعنا الأردني الذي يوسم بأنه “شاب” ولكنّ هؤلاء الشباب متعطلون وبنسبٍ مئوية كبيرة عن العمل والمشاركة، وما نسب المشاركة في الانتخابات على سبيل المثال بدءًا من المدارس واتحادات الطلبة في الجامعات، وليس انتهاء في البلديات ومجالس النواب إلا مؤشرًا على أنّ هؤلاء الشباب استبعدوا أو يستبعدون أنفسهم جراء ما يعيشون فيه من توترٍ وتوقٍ إلى انحيازهم نحو الإنتاج والعمل والذمّة المالية المستقلة بعيدًا عن ذويهم الذين يعانون أيضًا من قوة هذه الضغوط.
ويشدد محادين على أنّه من حيث الدقة العلمية نقول إن الذي نشاهده أعراضٌ ظاهريةٌ للمشكلة، وهي مستفحلة في جوهرها الاقتصادي والقيمي، وبالتالي طرق التعبير عنها تختلف بين شخصٍ محبط، وآخر مغترب، وثالث يتوق للتعبير بأنّه يعاني.
ويتابع حديثه بالقول: هذه الأشكال المختلفة عندما تلتقي في ظلّ مجتمعٍ نامٍ، والضغوط الإقليمية والاقتصادية ضاغطة عليه، نجد أنّ مثل هذه الممارسات قد تحدث، وبأشكالٍ جديدة، لماذا؟ لأنّ الأشخاص الذين يودون التذكير بأنفسهم سواءً بشكلٍ قاتلٍ عبر الانتحار، أو عبر الصراخ، أو عبر النماذج التي يقدمها البعض في العنف، “كلها مؤشرات على أنّ لدينا أزمة داخلية بحاجة لوقفة علمية”.
ترشيد دور الإعلام التوعوي
ويرى محادين في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ الإعلام مجرد ناقل لما يحدث، وأحيانًا نشعر أنّ المواطن الأردني لا يرغب في مواجهة نفسه عبر مرآة الإعلام، ونحن نتحدث عن الإعلام المنضبط الذي ينقل الصورة لغايات التوعية والإرشاد وهكذا، ويقابل باستياءٍ من الرأي العام، أنّ هذا لا يحدث لدينا، ونحن مجتمع محافظ، وليس من الدقة نقل مثل هذه الصور خشية أن يتم تقليدها.
ويضيف، نحن عمليًا دور الإعلام وبكل ما تعنيه الكلمة هو دورٌ كاشفٌ ناقلٌ للحقائق، وعلينا أن نتعامل ونستفيد من وجود السلطة الرابعة في حياتنا، لأنّها واحدة من أدوات تفريغ شحنات التوتر المحتقنة داخل الوجدان الشعبي، والأنا الفردية، وبالتالي أعتقد أن هناك ضرورة مهمة للاستثمار في الإعلام وإشاعة التوعية بصورة علمية.
ويختم حديثه بالاستدراك والقول: لكن، لعلّ التضخم في دور الإعلام وتأثيره في المتلقي، هو ضعف الإعلام الرسمي الحكومي عبر الحكومات المتعاقبة، وغياب المصدر الموثوق بالنسبة للمتلقي، فهو يساهم بشكلٍ واضحٍ بملأ الفضاء الإعلامي المعولم بحقائق ومعطيات ذات زاوية تحليلية أو ناقلة واحدة وليس كما هو الحال المفترض بكلتا العينين وبكلتا الصورتين، صاحب الحدث أو الحدث نفسه والتعقيب الرسمي والعلمي والسياسي على سرعة ما يعيشه مجتمعنا من تغيراتٍ وأحداث.
(البوصلة)